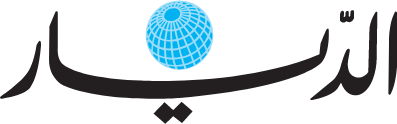كما كل صباح في أروقة لبنان وشوارعه، يصدح صوت فيروز، يملأ المكان بأنغام العمالقة،عمالقة العصر الذهبي أولئك الذين شكلوا وعينا الجمعي، وصاغوا لغة فريدة للفن والفكر والمقاومة، لكن صباح السبت الماضي لم يكن كأي صباح سبقه، فقد هز خبر رحيل زياد عاصي الرحباني، كيان وطننا الجريح.
لم يكن الخبر مجرد نبأ وفاة، بل كان كإسدال الستارعلى الفصل الأخير من فصول من تاريخ لبنان الثقافي، برحيل زياد عاصي الرحباني ابن صاحبة الصوت الملائكي، وابن الفوضى الجميلة التي حاول أن يرتبها على طريقته الساخرة. هذا الرجل الذي لم يكن فقط موسيقيا ومسرحيا ساخرا، بل كان مرآة قاسية لوطنٍ جريح، وصوتا غاضبا يشاكس السلطة، يعري تناقضات المجتمع، ويسائل القيم الزائفة بلغة تجمع بين العمق والبساطة، بين الألم والضحك الأسود.
ابن فيروز وعاصي أعاد تعريف الهوية الثقافية، فلم يكن يكتب ليروي قصة، بل ليحرض على التفكير. ولم يكن يغني ليرفه، بل ليفكك. فهو لم يرث مجد والديه فحسب، بل تمرد عليه وأعاد تشكيله، وأعاد توجيه البوصلة نحو الناس المهمشين، الفقراء، المقهورين، أولئك الذين جعل منهم أبطالا في مسرحه، وموضوعا في أغانيه، ومرآة لخطابه الساخر والناقد، فأعماله تشكل أرشيفا حيا لذاكرة شعب عاش الحرب والخيانة والانقسام.
كان زياد صوتا لا يشبه أحدا، كان مشروعا ثقافيا متكاملا أطل على الناس في السبعينيات وهو في مقتبل العمر، فأدهشهم بعمق طرحه وسخريته، موسيقاه كانت صوت الحارات لا القصور، صوت الأحلام المكسورة لا الأوهام الوردية. وزع لوالدته أجمل الأغاني التي اختزلت حزن بيروت ووجع الجنوب ولهيب الانتظار، وكتب "كيفك إنت"، "بكتب اسمك يا حبيبي"، "أنا عندي حنين"، "عودك رنان"، وغنى بصوته كلمات تمزق الصدر "بما إنو"، و "الحالة تعبانة يا ليلى" و "شو هالايام".
أما في مسرحياته، من نزل السرور إلى فيلم أميركي طويل، شي فاشل، وبالنسبة لبكرا شو؟ وغيرها من الأعمال فلم تكن عروضا ترفيهية، بل كانت مرايا تعكس الواقع المشوه، والمفارقة أن مسرحه بقي حيا بعد عقود من عرضه، وكأنه كتب لكل زمن لبناني مأزوم.
زياد لم يكن فنانا فقط، بل كان شاهدا على مرحلة كاملة من لبنان. فبرحيل زياد، يشعر اللبناني أن قطعة من وعيه ترحل، وأن نبرة الغضب المحببة تختفي، وأن الساخر الذي فهمنا قبل أن نفهم أنفسنا قد أسدل الستار. كان شاهدا وشهيدا من نوع آخر، شهيد الكلمة، شهيد السخرية، شهيد الصوت العالي.
خسرنا شاهدا حيا على زمن الكبار. هو آخر جيل العمالقة. وبرحيله، نطوي فصلا من تاريخ لبنان الثقافي. فنحن اليوم، في زمن منصات التواصل واستهلاك المعنى. نعيش فراغا مخيفا، فلا مسرح سياسي نقدي، لا شعر يوقظ، ولا أغنية تحمل قضيّة، نعيش عصر الانحطاط الفكري، حيث باتت السخرية تهريجا، والموسيقى ضجيجا، والمسرح ترفا نخبويا.
في وداع زياد نرثي وطنا ضاع، نرثي عصرا من الفكر الذبيح، والكرامة المخنوقة، والثقافة التي كانت مقاومة قبل أن تصبح مجرد صورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
رحل زياد الرحباني، وترك فراغا لا يملؤه سوى وجع الوعي، وحنين المسرح، وصدى نكتة قالها يوما وأصبحت جزءا من تراثنا الجماعي، ليبقى السؤال: ماذا بعد زياد؟
من سيكتب للحرب والحب والسياسة والناس بلغةٍ صادقة؟
من سيجرؤ على مخاطبة الناس بلغتهم، لا بل بوجعهم؟
من سيقول ما لا يقال؟
من سيضحك ويبكي في الجملة نفسها، من دون تصنع؟
من سيعيد للبنان شيئا من كرامته الثقافية، في زمن ذبح الفكر بالتسطّح الشامل؟
لكن الأمل يبقى في أن الجيل الذي تربى على زياد، قد ينهض يوما ليس فقط ليستذكره، بل ليواصل معركته، معركة العقل، معركة الفن النظيف، معركة الإنسان. فأرشيف زياد – موسيقاه، مسرحياته، مقابلاته، مواقفه – سيبقى دليلا على أن لبنان يوما ما، كان فيه فن له عمق، وسخرية لها هدف، ومثقف لا يشترى.
يتم قراءة الآن
-
![]()
صفا في بعبدا ورحال في عين التينة... طبخة بين «الاستاذ» و«العماد»؟ لقاءات براك ــ أورتاغوس الاسرائيلية «سلبية» والجواب الرسمي السبت السلاح الفلسطيني الى الواجهة: ضغط أم تهدئة أم توريط للدولة؟
-
![]()
سلام نتنياهو: لبنان مستوطنة "إسرائيليّة"
-
![]()
موفدان للرئيس الفلسطيني في لبنان لتنفيذ قراره بتسليم السلاح نجله ياسر يبحث عن العقارات... والفصائل المعارضة خارج القرار
-
![]()
مضمون ورقة الجيش يطمئن الثنائي ويرسم مسار المرحلة المقبلة خطاب مفصلي لبري في 31 آب... جعجع: للالتزام بقرارات الحكومة رفض اميركي للافراج عن ارهابيين يطالب بهم الشرع
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
23:37
الدوري الألماني لكرة القدم: فوز كاسح لبايرن ميونيخ على لايبزيغ (6-0) في افتتاح الموسم الجديد.
-
23:02
وزير خارجية بريطانيا: تحدثت والشركاء الأوروبيين مع وزير خارجية إيران لتجديد تأكيد مخاوفنا بشأن البرنامج، وعرضنا على إيران حلا دبلوماسيا يتضمن تمديد تخفيف العقوبات لكن الوقت ضيق.
-
23:02
بلومبرغ: وزير خارجية هولندا المستقيل يقول إنه لم يحقق توافقا بشأن إجراءات ذات معنى ردا على ممارسات "إسرائيل".
-
23:01
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: لدى حماس الآن 20 رهينة لكن العدد في الواقع قد لا يكون كذلك لأن اثنين منهم ربما لم يعودا موجودين.
-
22:34
هيئة البث "الإسرائيلية": الجيش بدأ تنفيذ خطة احتلال غزة ووسع من نطاق عملياته في جباليا والزيتون.
-
22:34
الخارجية الإماراتية: الممارسات "الإسرائيلية" تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.