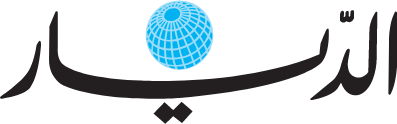يقترب اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يُصادف ٢٠ شباط من كل عام، ذلك الموعد السنوي الذي يطفو فيه الحديث عن القيم التي يُفترض أن تشكّل جوهر المجتمعات، لكنه غالبا ما يبقى مجرد شعار يُرفع في المحافل. فما الذي يجعل هذه المناسبة تستحق يوما عالميا يُخصَّص للحديث عنها؟ أهو اعتراف بتعثر تحقيقها؟ أم محاولة لتذكير العالم بأنها لا تزال بعيدة المنال؟
لا شك انه تم اعتماد هذا اليوم ليس احتفاءً بمنجزات كبرى، بل لأنه لا يزال هناك من يُقصى عن حقوقه الأساسية، ومن تُغلق أمامه أبواب الفرص، ومن يجد نفسه في هوة سحيقة من الفقر، بينما آخرون يحلقون في سماء الثراء الفاحش. إنه يوم يُفترض أن يكون لحظة تأمل ونقد، لا مجرد احتفال رمزي عابر. ولكن كيف يتم إحياؤه؟ ومن يستفيد حقًا من هذا التذكير السنوي؟
لذلك، لا تعد المساواة مجرد شعار يتردد في المؤتمرات، أو مادة تُدرّس في القاعات الجامعية، بل هي حق أصيل لكل فرد وضرورة تفرضها الفطرة قبل القوانين. إنها ليست فكرة نظرية تُناقش في الندوات، بل فعل يجب أن يتجلى في تفاصيل الحياة اليومية، حيث يحصل الإنسان على ما يستحقه من فرص وكرامة دون تمييز أو إقصاء. وتبقى المعيار الذي يُقاس به مدى إنسانية المجتمعات، فهي لا تعتبر رفاهية، بل أساس للاستقرار والنهضة.
مُهمّة إستطلاعيّة تفضح
تصدع بنية المجتمع اللبناني
لكن في لبنان، يبدو هذا المفهوم أقرب إلى حلم مؤجل، حيث تتلاشى ملامحه أمام واقع قاسٍ تكشفه مشاهد يومية لا تحتمل الصمت. ففي جولة ميدانية قامت بها "الديار"، برزت صورة قاتمة لطفل يدعى صلاح، لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، لكنه وجد نفسه في سوق العمل بدلاً من مقاعد الدراسة.
في أحد محال بيع الخضار في منطقة النبعة -برج حمود، يجلس صلاح بجانب الصناديق، يبيع الخضار للزبائن، واضعا في يده اليسرى محبساً وفي الأخرى سيجارة. يقول لـ "الديار": "ضاعت طفولتي بين اكوام البطاطا والبصل، واحاول ان اظهر للزبائن انه يمكن الاعتماد عليّ، وانني لم اعد طفلا".
لا يعد هذا المنظر حالة استثنائية، بل نموذجاً متكرراً في مختلف المناطق اللبنانية، حيث يتشظى مفهوم الطفولة تحت وطأة الفقر والعجز الرسمي. والسؤال الذي يفرض نفسه: أين وزارة الشؤون الاجتماعية من هذه الوقائع التي تكاد تصبح مألوفة؟ وأين مكتب حماية الأحداث، الذي يُفترض أن يكون خط الدفاع الأول عن هؤلاء الأطفال؟ ما جدوى وجوده إن كان دوره لا يتعدى كونه عنوانا إداريا بلا أثر حقيقي؟
في سياق متصل بهذا الوضع الإنساني، فإن مشهد الطفل صلاح لم يكن سوى فصل واحد من كتاب المأساة اللبنانية المفتوح على فصوله القاتمة، فالزيارات التي قامت بها "الديار" بينت ان الحقيقة مريرة يتقاطع فيها الفقر مع الإهمال الرسمي. وبدورنا كوسيلة إعلامية، لسنا مجرد ناقلين للخبر، بل نحن مرآة تعكس واقع المجتمع. وحين يتلاشى صوت الفقراء من الخطابات الرسمية، يصبح واجب الصحافة أن تصرخ باسمهم، أن تنقل وجوههم المنسية، وأن تسلط الضوء على زوايا مظلمة يحاول البعض تجاهلها.
ما بين غبار الزمن وتلكؤ المسؤولين
"عجائز" أرهقها العوز!
من جهة أخرى، في إحدى زوايا الادراج المهملة في الاشرفية، كان هناك رجل ينام ملفوفا ببقايا ثيابه، وكأنه يحاول الاحتماء من برد التجاهل قبل برودة الطقس. لم يكن موقفاً مؤقتاً، بل صفعة تسأل: أين الانصاف المجتمعي في لبنان اليوم؟ كيف يمكن الحديث عن مجتمع متوازن حين يصبح الرصيف مأوى، والدرج سريرا، والسماء سقفا لمن سُلبت منه أبسط مقومات الحياة؟
من جهته، يوضح مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ "الديار" ان "هذه الاحداث تعتبر أكثر من مجرد معاناة فردية، وهي مؤشر خطر يدل على تصدع المنظومة الاجتماعية. فالفقر والتشرد ليسا مجرد نتائج أزمات اقتصادية، بل هما نتاج تراكم طويل من الإهمال، حيث تتحول الدولة من كيان راعٍ إلى شاهد صامت".
اضاف المصدر "حين يصبح النوم في العراء أمرا مألوفًا، فهذا يعني أن العدالة لم تعد ضائعة فحسب، بل أصبحت مفهوماً غريباً عن الواقع اللبناني". وعما اذا ستتمكن الوزيرة الجديدة حنين السيد من احتواء هؤلاء في المستقبل القريب؟ المصدر يلتزم الصمت!
يعود المصدر ليشدد على ان "القسط الاجتماعي ليس فقط ميزان يُفترض أن يوزع الحقوق بالتساوي، بل هو خيط رفيع يفصل بين الحاجة الحقيقية والاستغلال، بين الشظف الذي يُفرض قسرا، والتسول الذي يتحول إلى حرفة".
مساحة رمادية تلتقي
فيها الضرورة بالخداع
الجدير بالذكر هنا، انه خلال تحقيقاتنا الميدانية رصدت "الديار" مشهدا يكشف جانبا آخر من هذا التناقض المتغلغل في الحياة الاجتماعية في البلاد، حيث لم يعد التسول حكرا على الأطفال أو كبار السن، بل أصبح مساحة رمادية تلتقي فيها الضرورة بالخداع، بحيث لم يعد مشهد الأطفال الذين يمسحون زجاج السيارات قبل مدّ أيديهم طلبا للمال، هو الوحيد الذي يطغى على الطرقات. هذه المرة، كانت هناك سيدات يقمن بالفعل نفسه، بإصرار مدروس، وكأن الأمر لم يعد خيارا فرديا بل تحول الى نمط متكرر.
لكن المفارقة لم تتوقف عند هذا الحد، ففي زاوية بعيدة عن أعين المارة، جلست إحداهن تمسك بهاتف ذكي يفوق في حداثته ما يمتلكه كثيرون، ممن يكدّون للحصول على قوت يومهم. وعلى الطرف الآخر من الصورة، كان هناك رجل مسن، يجلس على قارعة الطريق، يمد يده بصمت لا يمارس أي حيلة، ولا يبرع في استدرار العطف. الفرق بين المشهدين لم يكن في الفقر وحده، بل في معنى الحاجة نفسها، في الخط الفاصل بين من يستجدي الحياة، ومن يتقن لعبة الاستعطاء.
وبالحديث عن هذه الوقائع، يرى المصدر في وزارة الشؤون "ان هذا الوضع هو انعكاس لتحولات أعمق في المجتمع، حيث يصبح الحرمان مسرحا، وتتحول الحاجة إلى أداة، فيما يبقى العاجزون عن التلاعب بمظاهرهم هم الضحايا الحقيقيون. الاستجداء المنظم لم يعد مجرد فعل فردي، بل بات أشبه بمنظومة اقتصادية غير معلنة، تخلق طبقات داخل الفقر نفسه، حيث يتوارى المحتاج الحقيقي خلف ضجيج من يتقنون التمثيل، وبين الاثنين، تُدفن العدالة الاجتماعية تحت ركام من الفوضى الاجتماعية".
نعم الشعور الوطني "واجب"!
في مقابل ذلك، أظهرت الجولات الميدانية التي قامت بها "الديار" في بعض احياء العاصمة، أن هناك شعورا متزايدا بأن الفجوة بين الدولة والمواطنين تكبر يوماً بعد يوم، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة. وفي وقت يقترب فيه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يبدو ان هذا الحق، الذي يُفترض أن يكون جزءاً من نسيج المجتمع اللبناني، بعيد المنال لعدد كبير من المواطنين، الذين لا يزالون يُحرمون من أبسط حقوقهم.
بناء على ما ذكر، إذا نظرنا إلى دور المؤسسات المعنية، فإن الواقع يطرح تساؤلات مقلقة. اذ كيف يمكن لمكتب حماية الأحداث، الذي يُعتبر حصناً لحماية الأطفال من الاستغلال، أن يكون غائباً عن مشهد فئات من الأطفال القاصرين، الذين يعملون في الشوارع أو يعيشون في ظروف مرعبة دون تدخل ملموس أو تقديم الدعم الكافي لهم؟ ألا يعدّ هذا إهمالاً واضحاً لحقوق هؤلاء الأبرياء؟ والأكثر إيلاماً، كيف يمكن أن نغفل عن كبار السن الذين يقاسون الصمت على أرصفة الشوارع، لا يجدون من يلتفت إليهم أو يهتم برعايتهم في أواخر أعمارهم؟
في الوقت الذي تدّعي فيه وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم المساعدات للمحتاجين، نرى أن هذا الدعم غالباً ما يصل إلى غير مستحقيه، بينما يتمثل الشقاء والفاقة في وجوه أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إلى يد الرحمة.
ربطا بما تقدم، فان هذه التساؤلات يجب أن تدفعنا لإعادة التفكير في دور وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة. نحن لا نحتاج إلى حقيبة جديدة مثل "وزارة للسعادة" قد تكون مجرد تعبير عن ترف فكري، في بلد يئن تحت وطأة الأزمات، بل نطالب بإعادة هيكلة المؤسسات الموجودة، لتكون أكثر فعالية وقدرة على معالجة المشكلات الحقيقية للمواطنين. العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل هي عملية مستمرة تتطلب تضافر الجهود الحكومية مع المجتمعية.
ومن غير المقبول أن تظل فئات واسعة من الشعب اللبناني، مثل الأطفال المتسولين وكبار السن المشردين، تُترك لمصيرها في الشوارع، في الوقت الذي تتحدث فيه الدواة عن رفاهية وسعادة المواطن في أطر بعيدة عن الواقع.
إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق فقط عبر الشعارات، بل من خلال عمل دؤوب ومؤسسات تحترم حقوق المواطنين، وتقدم لهم ما يستحقونه من دعم ورعاية. ولعل ما يمكننا التأكيد عليه في هذا السياق هو أن العدالة الاجتماعية، كما السعادة ليستا نعيما، بل ضرورة تتطلب اهتماماً جاداً ومسؤولية من الجميع، بدءاً من الحكومات وصولاً إلى الأفراد في المجتمع.
في النهاية، لا يمكن تجاهل اولئك الذين يعانون في صمت، مثل المسن الذي ينام على قارعة الطريق أو الطفل الذي يعمل في محل تجاري وهو في عمر الزهور. على الدولة أن تسأل نفسها: أين هي العدالة الاجتماعية؟ أين هو مكتب حماية الأحداث؟ وأين هي وزارة الشؤون الاجتماعية من كل هؤلاء؟
يتم قراءة الآن
-
![]()
جلسة السلاح تحرّك العاصفة... وماكرون يتدخّل لتفادي الانفجار برّاك ينسحب إلى موناكو ورسائله تربك بيروت بإنتظار التشكيلات القضائية: ملفات حساسة وشخصيات نافذة على الطاولة
-
![]()
هكذا الإعداد لحرب أهليّة في لبنان
-
![]()
إذا لم يُسلّم حزب الله سلاحه
-
![]()
«الشعب العنيد» يُودّع زياد... تباينات حول عقد جلسة حكوميّة لبحث ملف السلاح... ووطن مُعلّق على «تغريدة»! حوار عون ـ حزب الله يسير ببطء... وتشكيل لجنة مُشتركة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:31
أشغال على جسر الهوم سيتي - جونية - المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل السير في المحلة.
-
22:08
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على عشرات شركات الشحن والناقلات والأفراد الذين يصدرون النفط من إيران وروسيا.*
-
21:33
مستشفيات غزة: 73 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 61 من طالبي المساعدات.
-
21:32
البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.
-
21:32
"رويترز": وزير الخارجية المصري بحث مع المبعوث الأميركي ويتكوف تكثيف الضغوط للتوصل لهدنة في قطاع غزة قبل زيارة المبعوث "لإسرائيل".
-
21:31
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: سنبرم اتفاقا واضحا للغاية مع الصين والأمور تسير على ما يرام.